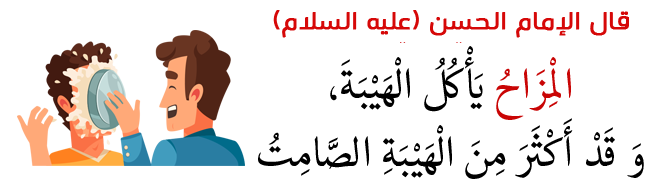
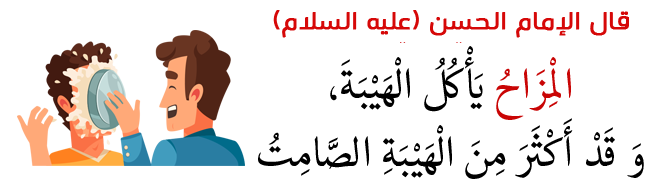

 القانون العام
القانون العام
 القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري و القضاء الاداري
 المجموعة الجنائية
المجموعة الجنائية
 قانون العقوبات
قانون العقوبات 
 القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية 
 القانون الخاص
القانون الخاص
 قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات و الاثبات
 المجموعة التجارية
المجموعة التجارية
 علوم قانونية أخرى
علوم قانونية أخرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
التاريخ: 1-9-2020
التاريخ: 15-6-2016
التاريخ: 2024-04-15
|
على الرغم من النقد (1) الذي وجه لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري، الا أنه لم يقلل من شانه أو ينتقص أو يقلل من اقبال أغلب التشريعات على الأخذ به؛ لأنه جاء من الاحساس بالسلبيات التي خلفها نظام الأدلة القانونية (الاثبات المقيد) (2)، إذ إن القاضي وفقاً لهذا المبدأ (الاثبات المقيد) ليس بإمكانه الحكم إذا لم تتوفر لديه الأدلة التي يحددها القانون، وعليه يكون غير قادر على تحقيق العدالة بين الخصوم في الدعوى، ونتيجة لهذه المساوئ حاول الفقه ایجاد نظام جديد للإثبات يكون أكثر عدالة، فكان نظام الاثبات الحر أو المطلق والذي لا يرسم القانون فيه طرقاً محددة يقيد فيها القاضي، بل يكون حراً في أن يكون عقيدته في المنازعة المعروضة عليه من أي طريق يراه مناسباً، فالخصوم احرار في تقديم الأدلة التي بإمكانهم الوصول اليها، والقاضي له مطلق الحرية من أجل التوصل إلى الحقيقة القضائية التي يراها مؤدية إلى اقتناعه أن لا يتقيد بطريقة معينه في الاثبات، اذ يتمتع بسلطات واسعة في نطاق اجراءات الاثبات وتحضير الدعوى، وغيرها من المظاهر التي تمثل الدور الايجابي والتي تمكنه من الكشف عن الحقيقة قبل أن يفصل في الدعوى وهذه مظاهر تميل إلى التطور والاتساع تدريجياً، ومما يمتاز به هذا النظام أنه يعطي المجال الواسع للقاضي لأجل التوصل لتحقيق العدالة، إذ تكون الحقائق القضائية التي يتوصل اليها القاضي أقرب الى الحقائق الواقعية بما يمكنه من أن يطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية، ويقوم هذا المذهب على مبدأين أساسيين : الأول: أدلة اثبات غير محدده، والثاني: عدم تحديد حجية أدلة الاثبات، ففيما يتعلق بالمبدأ الأول فالقانون لا يحدد الأدلة للأثبات، فيمكن ان يقع الاثبات بأي دليل، فالذي يقع عليه عبء الاثبات مسموح له أن يلجأ إلى أي دليل من أدلة الاثبات لغرض اثبات صحة ما يدعيه، وعليه يشترط في الأدلة التي يستند إليها القاضي أن تؤدي إلى اقتناعه بصحة الواقعة، فالقانون لا يعمل على تقييد القاضي بأدلة اثبات محددة وإنما يترك له استنباط الدليل من الوقائع المعروضة عليه، ولذلك يشترط أن يكون هذا الدليل منطقياً لا يخالف قاعدة قانونية أو مبدأ من المبادئ الاساسية في التشريع، فإذا خالف ذلك كان الحكم الذي صدر بناءً عليه ليس له قيمة لمخالفته للقانون، أما المبدأ الثاني فيعتبر هذا المبدأ إنَّ جميع أدلة الاثبات مقبولة، وإن أي تسلسل لا يظهر بينها من حيث الحجية، لذا فالقاضي تبقى له الحرية في الترجيح بين الأدلة، حيث يترك له تقدير الادلة لأنه لا يكون لأي دليل من أدلة الاثبات قوة قانونية يمكن أن تفرض على القاضي (3).
وهذا المذهب هو خير من يعمل على تحقيق العدالة لأنه يطلق سلطة القاضي في تكوين اقتناعه وذلك برفع العوائق عنه في سبيل التوصل للحقيقة (4).
ويلاحظ أن مذهب الاثبات الحر يفسح للقاضي المجال الواسع في اختيار الأدلة التي يبنى عليها قناعته، فهذا النظام يشكل جوهر الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري، وعليه تذهب الباحثة مع ما ذهب إليه الفقه في تفضيل هذا المذهب في الاثبات، وأن كان هنالك بعض السلبيات، والتي تتمثل في اطلاق يد القاضي تجاه الأدلة وهذا يؤدي إلى الاخلال بالثقة في الاحكام، وأيضاً يعمل على عدم الاستقرار في المعاملات، لذا يجب تلافي هذه السلبيات من أجل حفظ حقوق جميع أطراف الدعوى وتحقيق أقصى أنواع العدل بين الخصوم.
في حين هناك مذهب ثالث اطلق عليه الفقه بمذهب الاثبات المختلط جمع بين مفاهیم مذهب الاثبات الحر ومذهب الاثبات المقيد، فأجاز للقاضي أن يوجه أطراف الدعوى، وأن يستكمل الأدلة الناقصة، وان يستوضح عن النقاط الغامضة في وقائع الدعوى المعروضة أمامه واتخاذ ما يلزم اتخاذه من اجراءات الاثبات، باشتراط عدم التعارض مع تقيد القاضي بالأدلة التي حددها القانون، أي إن دور القاضي يكون ايجابياً في مجال الأدلة التي لم يحدد لها القانون قوة معينة، مع حصر الأدلة وترتيبها أجل تحقيق الاستقرار في التعامل، وفي ذات الوقت يعمل على تجاوز تقييد سلطة القاضي (5)، ويلاحظ على هذا النظام بعض الأمور منها إنّ الحقيقة القضائية قد تقترب من الحقيقة الواقعية بحسب هذا النظام إلا أن ذلك لا يصل إلى حد يجعل للأدلة قوة قطعية في الاثبات فتبقى هذه الأدلة ظنية، والحقيقة القضائية لا تعدوا أن تكون مجرد احتمال راجح وليست حقيقة قطعية، غير إنه من الناحية العملية لابد من الاكتفاء بالحجج الظنية ما دامت ،راجحة، لأنَّ اشتراط الحجج القاطعة يجعل باب الاثبات مقفلاً أمام القاضي، وفي الحقيقة إن مذهب الاثبات المختلط يختلف من نظام تشريعي إلى آخر، فمن النظم ما يقلل من القيود التي تفرض على حرية القاضي، حيث يكون هنالك التقارب بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية، ومنها ما يتشدد في القيود ولو كان هنالك تباعد بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية، وخير هذه النظم هو الذي يعمل على الموازنة بين الاعتبارين (6).
وعلى مستوى التشريعات فإنها تفاوتت في تبني أحد هذه المذاهب ( المقيد، الحر، المختلط ) في اثبات الدعوى الإدارية(7).
ومن المسلم به إنّ الدعوى الإدارية تتسم بأن أحد أطرافها سواء أكان مدعياً أم مدعياً عليه هي الإدارة التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة، تلك السلطة التي تجعل الإدارة الطرف الأقوى في الدعوى، ولغرض تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة ومصلحة الفرد منح المشرع القاضي الإداري دوراً ايجابياً في تسييرها فهو الذي يقوم بإجراءات الاثبات ولا يتركها للأفراد بل هو نفسه يقوم بهذا الجهد الشاق من أجل البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة وإن كان لا يحق للقاضي الإداري في الغالب (8) أن يحل محل الإدارة وان لا يصدر لها أوامر فهي سلطة عامة، وإصدار الأوامر يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات(9)، ومن ثم وجب أن يمنح القاضي الإداري الحرية التي تجعله من القدرة بمكان على تحقيق العدالة بين الخصوم، خاصة بعد ظهور الأدوات التي تساعد على تسهيل عملية الاثبات والتي تتمثل في الفاكس والتلكس والحاسب الآلي التي تعتبر غير مرتبطة بشبكة المعلومات العالمية، في حين هنالك أدوات مرتبطة بشبكة المعلومات العالمية مثل الويب (web) ، البريد الالكتروني (10)، فهذه الادوات وإن كانت لا تتماشى مع طبيعة الدعوى الإدارية التي تعتبر من ابرز سماتها الكتابة، وأن تكون المستندات فيها من النوع المادي، وعليه يجب أن يترك للقاضي الحرية في التقدير بين هذه الادوات لان العملية القضائية لا تسير وفق إليه معينة، بقدر ما تنطوي على قواعد أخلاقية أثر المشرع على نفسه أن يترك الحرية في التقدير للقاضي الإداري دون أن يخضعه لقواعد محددة في هذا المجال، فلا يمكن صياغة قواعد ثابتة تفرض على قناعة المحكمة لأنّ هذا الأمر يتعارض مع سير العمل القضائي في الدعوى الإدارية.
فالطبيعة الموضوعية للدعوى الإدارية واتصالها بالصالح العام من جهة، وعدم توازن أطرافها من جهة أخرى، كذلك شحة النصوص الاجرائية التي تنظم قواعد الاثبات أمام القضاء الإداري، كل ذلك أدى إلى منح القاضي الإداري الدور الأقوى في الدعوى (11)
مما سبق ذكره نخلص إلى أن الأساس الفلسفي لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري يكمن اساساً في مذهب الاثبات الحر والذي يعطي للقاضي الاداري الحرية في اختيار الدليل الذي يبني عليه قناعته والباحثة تذهب مع ما ذهب اليه مذاهب الاثبات الحر كونه مذهب الذي يتناسب مع عمل القاضي الادري
____________
1- وجه لمبدأ الاقتناع الذاتي العديد من الانتقادات منها انه يؤدي الى عدم الاستقرار في المراكز القانونية وذلك لاختلاف التقدير من قاضي الى اخر، و لتباين القضاة في فكرهم وقناعاتهم، فالقضاة بشر غير منزهين عن الخطأ أو الجور أو التحكم، فالإمر متروك للقاضي يسلم فيه المتقاضون أمرهم له دون ادنى تقييد السلطاته، معتمدين على نزاهته وعدله، وبالتالي اذا جار القاضي او ظلم ابتعدت الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية اشار الى ذلك د. سحر عبد الستار امام يوسف دور القاضي في الاثبات دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2007، ص 16.
2- يؤسس نظام الاثبات المقيد على الحد من حرية القاضي في قبول ادلة اثبات لغرض توحيد الاحكام القضائية في القضايا المتشابهة ومنعة من التعسف في التقدير والترجيح في الادلة، فدور القاضي وفقاً لهذا المذهب هو دور سلبي قاصر على ما يقدمه الخصوم من ادلة اجاز القانون تقديمها، فليس للقاضي أن يقدم ما يشاء من ادلة الاثبات، بل انه مقيد في نطاق ما حدده القانون كما ان المشرع يحدد القيمة القانونية لكل دليل من ادلة الاثبات وفق تسلسل محدد ابتداء من الدليل الاقوى الى الدليل الاضعف من ناحية قوة الحجة في الاثبات، فالقانون مثلاً يحدد الحالات التي تقبل فيها الشهادة والقرائن وما يميز هذا النظام انه يحقق الاستقرار في التعاملات، كما انه يكون من الوضوح للمتقاضين، لكن ما يحسب على هذا النظام من سلبيات تتمثل في انه يفرض من القيود على القاضي ربما تحول بينه وبين تحقيق العدالة اشار الى ذلك صادق محمد علي الحسيني - محمد حسن جاسم الظالمي، خصوصية الاثبات امام القضاء الاداري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العراق، العدد 39، 2.19، ص170.
3- د. عصمت عبد المجيد بكر ، النظرية العامة للأثبات في القانون المقارن، ط ا منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2019، ص 36-37.
4- رعد حمود خلف حجية وسائل الاثبات امام القضاء الاداري (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه في القانون العام مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية ، لبنان، 2020، ص23.
5- صادق محمد علي الحسيني - محمد حسن جاسم الظالمي، خصوصية الاثبات امام القضاء الاداري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العراق، العدد 39، 2019 ، 170-171
6- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات المدني، ط 2 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 27
7- اغلب التشريعات اللاتينية ومنها التشريع الفرنسي والايطالي والبلجيكي اخذ بهذا النظام، وكذلك سائر القوانين العربية كالقانون المصري والليبي والاردني، اما المشرع العراقي فقد كان موقفه توفيقاً بين المذهبين، اي انه اخذ بمذهب الاثبات المختلط، وذلك من خلال ايراد هذا الأمر في الاسباب الموجبة لقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فقد جاء فيه ( وفي صدد طرق الاثبات تخير القانون الاتجاه الوسط بين انظمة الاثبات المقيد والاثبات المطلق فعمد الى تحديد طرق الاثبات ولكنه جعل للقاضي دوراً ايجابياً في تقدير الأدلة وفي التحرك الذاتي الموصل الى الحكم العادل والى الحسم السريع ...) اشار الى ذلك د. فائز ذنون جاسم ادلة الاثبات، ط 1 ، مكتبة صباح، بغداد، 2014، ص13.
8- اجاز المشرع العراقي لمحكمة القضاء الاداري تعديل القرار الاداري في المادة (7/ رابعاً) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 والتي تنص على ان تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام...).
9- د. سيد أبو عيطة المرافعات الادارية امام مجلس الدولة (دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014، ص 105 – 106.
10 - د. حسن فضالة موسى، التنظيم القانوني للإثبات الالكتروني (دراسة مقارنه)، ط1، دار السنهوري، بغداد، 2016، ص 45 وما بعدها.
11- قاسمي سعيدة المبادئ الاساسية للإثبات في المواد الادارية رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند أولحاج الجزائر، 2015، ص 72.



|
|
|
|
دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
|
|
|
|
|
|
|
تنشيط أول مفاعل ملح منصهر يستعمل الثوريوم في العالم.. سباق "الأرنب والسلحفاة"
|
|
|
|
|
|
|
الطلبة المشاركون: مسابقة فنِّ الخطابة تمثل فرصة للتنافس الإبداعي وتنمية المهارات
|
|
|