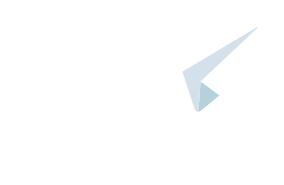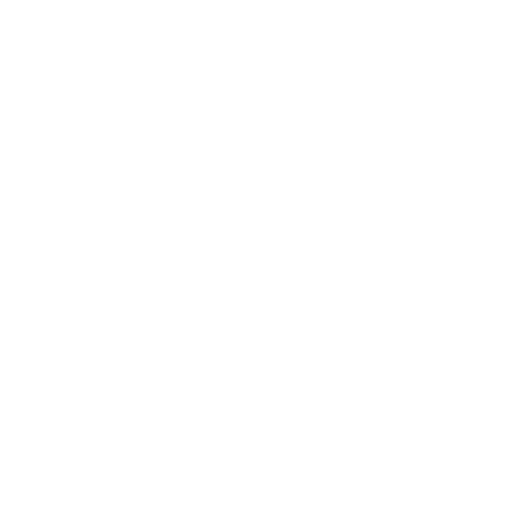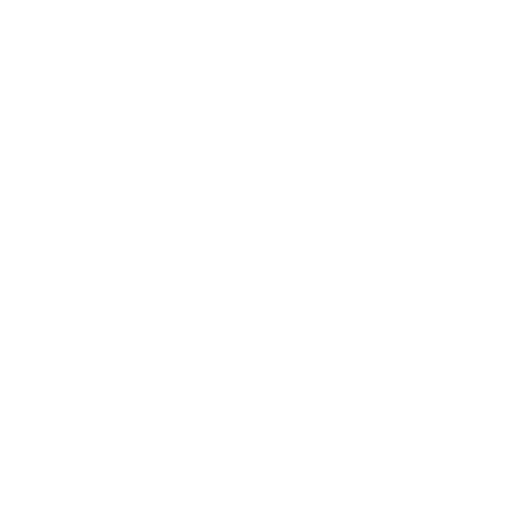الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات


المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية


التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة
مهمات الجامعة
المؤلف:
أ. د. عبد الكريم بكَار
المصدر:
حول التربية والتعليم
الجزء والصفحة:
ص 229 ــ 235
2025-08-15
860
يكتسب التعليم الجامعي اليوم أهمية متزايدة نظراً لتشعب العلوم والمعارف وتكاثر التخصصات، وارتقاء شروط العيش الكريم. وحين تجتاح مجتمعاً من المجتمعات رياح التقلب والاضطراب السياسي، فإن الجامعة تكون من بين أهم المؤسسات التي تحافظ على توازن المجتمع، وتضمن له نوعاً من الاستقرار الثقافي. وهي لما تتمتع به من قوة الاستمرار أو (الحرون) في وجه التغيير، تشكل إطاراً مرجعياً للملاءمة بين القديم والجديد.
في الجامعات يتم إعداد المعلمين للمراحل التعليمية المختلفة، وهذا يعني أن الجامعة الناجحة، تسهم بحظ وافر في إصلاح المراحل التعليمية المختلفة، ورفع مستواها، وهذا يعطيها نوعاً من الأولوية في العناية والتطوير.
ومن وجه آخر فإن الفجوة الهائلة بين أمة الإسلام والأمم الأخرى على المستوى العلمي والتقني، لا يمكن ردمها عن طريق المعارف الأولية العامة، وإنما عن طريق المعارف المتقدمة، والجامعات هي أكثر المؤسسات أهلية لإنتاج تلك المعارف، فهي تتيح من خلال المناهج وأساليب البحث العلمي المختلفة - التطبيقات العملية للأفكار المنهجية والتحليلية المتعلقة بمشكلات المجتمعات الحديثة (1).
إن خير ما يشير إلى أهمية التعليم الجامعي، هو أن نعمد إلى حذف وظائف الجامعة وإلغائها؛ لنرى أية وضعية معرفية وحضارية تكون لدينا، ولنتصور مجتمعاً من غير معلمين ولا مهندسين ولا أطباء ولا صناعيين ماذا ستكون حاله؟!
إن الجامعات قد أضحت في نظر الأمم رمزاً من رموز السيادة الوطنية، وعنصراً مهماً من عناصر تكوين الدول، ويذكر في هذا الصدد أن الزعيم الصهيوني (حييم وايزمان) قال عند افتتاح الجامعة العبرية عام 1924، (الآن تم بناء الدولة) (2).
إذا كانت الجامعة تحتل هذه المكانة الخطيرة، فإن علينا أن نتساءل عن المهمات التي على التعليم العالي أن ينجزها للأمة، وعن الأهداف التي ينبغي أن يحققها؟
ولعلي أوجز ما أراه في هذا الصدد في الآتي:
1- إرساء تقاليد علمية.
لا نستطيع أن نؤسس مجتمعات، تصوغ أعرافها وعلاقاتها وأنماط تفكيرها على قواعد علمية صحيحة ما لم نرسخ في حياتنا تقاليد ثقافية بحثية، تساعدنا على تكوين أجواء ملائمة للإبداع والنمو العلمي، وتحجم في الوقت نفسه من الزيف والزغل الذي كثيراً ما يتفشى في الأوساط العلمية.
الجامعات بما هي أوعية وأطر لإنتاج المعرفة ونقلها وغربلتها، تستطيع أن تفعل ذلك. ولعل أهم التقاليد التي ينبغي التركيز عليها في هذا المجال هي: النزاهة العلمية، والدقة في النقل، والاعتراف بالفضل لأهله، والموقف الموضوعي من الأخبار المنقولة، والانفتاح على الجديد، وتقبل النقد، والتشجيع عليه، والتفكير المنطقي، وهذا في الحقيقة لن يتم على الوجه المطلوب، ما لم يكن الأساتذة في الجامعة على مستوى جيد من الأهلية والخبرة.
2- تمليك الطالب منهجاً للتعامل مع المعرفة.
إن السنوات الأربع أو الست التي يقضيها الطالب في الجامعة – ليست كافية لاطلاعه على القسط الكافي من المعرفة؛ ولذا فإن من أهم ما يمكن للجامعة أن تتيحه لمنسوبيها (المنهج العلمي) الذي يمكنهم من التعامل الصحيح مع العلوم والمعارف. صحيح أن الجامعات تتيح قدراً من المعارف المتخصصة والعامة، لكن ذلك القدر إذا لم يرتكز على رؤية منهجية، فإنه سيكون أفضل وسيلة لتخريج نصف طالب علم، يتملكه من الغرور بمقدار ما يملك من النظر القاصر!. إن الذي يملك معلومة، كمن يملك قطعة ذهبية، أما الذي يملك منهجاً، فهو كمن يملك مفتاح منجم من الذهب، وشتان ما بينهما!
إن تعليم طالب القراءة المثمرة، أو محددات التعامل مع النص التاريخي، أو أسلوب الاستفادة من معجم، أو ملامح العلاقات الجدلية... يعد جزءاً من تكوينه المنهجي، وذلك أجدى بكثير من حفظ معاني بعض الكلمات، أو الاطلاع على عشرة كتب في التاريخ...
الشيء الآخر الذي يمكن للجامعة أن تفعله على هذا الصعيد، هو قدر من التوازن المعرفي، فالعلم عبارة عن معرفة منظمة والجامعة من خلال مواد التخصص، ومن خلال المواد التربوية والمواد المساعدة ومواد الثقافة العامة - توجد الأساس للتوازن المعرفي المطلوب هذا التوازن هو الذي يحول بين إيجاد مثقف منغلق، ومثقف مشوه الرؤية، وهو الذي يتيح المجال أمام تكوين أعداد كبيرة من الناس المهتمين بالشأن العام، العارفين بما يتطلبه التقدم الحضاري من خطط وجهود وأدوات.
3- تكوين الرجل الحساس:
متطلبات العيش في هذا الزمان، ومتطلبات التأثير في الحركة الاجتماعية - أضحت اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، نظراً لكثرة المعطيات التي يتطلبها القرار الصحيح على المستوى الفردي، وعلى المستوى الجماعي. لا تستطيع الجامعات - أن تقول كل شيء لطلابها، ولكنها تستطيع أن تنمي لديهم مجموعة من (الحساسيات) التي تساعدهم على اتخاذ المبادرات والمواقف الصحيحة، كما تساعدهم على جعل ردود أفعالهم تجاه أحداث الحياة أكثر رشداً وتنظيماً، ولعل أهم ما ينبغي تكوين الحساسية نحوه ما يلي:
أ- البعد التاريخي لأمة الإسلام بما حواه من مجد وفتوحات وإنجازات، وما تضمنه من مشكلات وأخطاء وانكسارات. تنبع أهمية التاريخ لأمة عريقة كأمتنا من أنه يشكل الخلفية الثقافية لكل جوانب المعرفة التي نعالجها، كما أن نظامنا الرمزي مكون من معطيات منهجية وتاريخية. ليس المهم أن يحفظ الطالب تفصيلات الحوادث التاريخية، ولكن أن يشكل انطباعات واضحة عن مجريات التاريخ وسنن الله - جل وعلا - في القرون التي خلت، إلى جانب فهم عميق لطبائع الأشياء ومنطقها واتجاهات تطورها. إن استيعاب الواقع، لا يتم من غير استيعاب حسن للتاريخ ما دامت جذور الواقع النفسي والاجتماعي والتربوي والسياسي... الذي نعيشه تضرب في أعماق الزمن. وعلى نحو عام، فنحن لا نفهم علماً حتى نفهم تاريخه.
ب- كل التصرفات التي يتصرفها البشر، هي ثمرات نسيج معقد من طبائعهم وثقافتهم وعقائدهم وتأثير البيئة فيهم. ويحتاج الرجل الحديث إلى امتلاك حس مرهف وبصيرة نافذة نحو ما هو مشترك بين الناس جميعاً، وهو (الطبيعة البشرية) بما تشتمل عليه من دوافع وغرائز وأشواق وتطلعات؛ حتى يفهم رجال المستقبل المنطق الذي يحكم تصرفات البشر، والعلل الخفية لها. وبذلك يتمكنون من ضبط أنفسهم، وتحييد العناصر السيئة من سلوكهم، إلى جانب بناء علاقات حسنة وواضحة مع أبناء مجتمعاتهم.
ج- في عصر التغيرات السريعة يصبح تعليم الطلاب الجامعيين (التكيف) ومهارات الاتصال - أمراً في غاية الأهمية، فمن غير خبرة بهذا وذاك يمكن للطالب أن يضحي فريسة للسلبية، أو الاندماج الكلي دون تمييز، وهما مصدران للتحلل الذاتي في أيامنا هذه!
وأستطيع القول: إن الانقسام الذي نلحظه بين كثير من مثقفينا حول كثير من قضايانا الجوهرية، ما هو إلا من نتائج تقصير الجامعات في أداء مهامها نحو هاتين المسألتين والدليل على ذلك أن أقساماً محدودة جداً فيها - كقسم إدارة الأعمال - تلك التي تدرس مقرراً لطلابها حول التكيف أو مهارات الاتصال، كما أن ضعف الربط بين المناهج المختلفة، وضعف ربط المناهج برؤيتنا الحضارية وفلسفتنا الحياتية أدى إلى ما نشاهده من ضعف التكيف وضعف روح المبادرة الفردية.
د- الحساسية نحو مجمل التحديات التي تواجهها الأمة على الأصعدة المختلفة، إلى جانب الأهداف التي ترنو إلى تحقيقها. وهذا الموضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل الإحباط الذي تعاني منه الأجيال الحاضرة، وفي ظل سيطرة الهموم الشخصية على معظم الناس. ويؤسفني القول: إن التقدم على هذا الصعيد، يتسم بالبطء والارتباك. ويبدو أن ما هو متاح من هامش حرية التعبير لا يكفي لأكثر مما هو حاصل الآن؛ مع أن الوعي بذلك شرط أساسي للوصول إلى محكات نهائية في مسائل التغيير والإصلاح الاجتماعي.
4- إنتاج المعرفة المتقدمة:
تمثل الجامعة المؤسسة الرئيسة لاحتضان (البحث العلمي)، فعلى الرغم من وجود مراكز البحوث المستقلة في أماكن كثيرة، إلا أن الجامعات هي التي تتولى القسط الأكبر من هذه المهمة؛ فالدراسات العليا، هي أقسام تدريب على كتابة البحوث، وإجراء التجارب، كما أن لأساتذة الجامعة إسهامات قيمة في هذا المجال.
في البلدان المتقدمة يخصص جزء كبير من ميزانيات الجامعات للبحث العلمي والبحوث التطبيقية خاصة، مما ساعدها على تجديد نفسها، وتقديم الخدمات العلمية للمصانع والشركات والمؤسسات السياسية والاجتماعية المختلفة. كثير من جامعاتنا لا يختلف في مسألة البحث العلمي عن الثانويات، إلا أنها أكثر ازدحاماً وهي لعدم صلتها بالجديد، تدرس نظریات مضى عليها عقود، وكثير منها صار منسوخاً، على حين يدرس الطلاب في البلاد المتقدمة النظريات التي تم التوصل إليها قبل عام؛ وكثيراً ما يكون الطلاب أول من اطلع على بعض النظريات الحديثة، بسبب أن أساتذتهم الذين يدرسونهم هم أصحاب تلك النظريات!.
5- خدمة المجتمع:
إن السوية الثقافية العامة لأكثر أفراد الأمة الإسلامية، هي أدنى بكثير مما هو موجود لدى كثير من الشعوب الأخرى، ورفع تلك السوية، يحتاج إلى جهود هائلة، وفي كل اتجاه. إن المكانة المرموقة التي تحتلها الجامعات في مجتمعاتها، تمنحها حق الريادة، وترتب عليها في الوقت نفسه مسؤولية النهوض بالبيئة المحيطة بها. والجامعات بما تملكه من إمكانات علمية ومادية تستطيع حقاً - لو أرادت - أن تصبح مراكز إشعاع حضاري؛ وهي بحاجة إلى هذه الوظيفة، حتى تكسر حواجز العزلة التي تفصلها عن الناس حولها.
ما يمكن أن تقوم به الجامعات من الارتقاء بالمجتمع والخدمة له كثير جداً، نذكر منه:
ـ تبسيط المعرفة التي تقدمها لطلابها على نحو يمكّن جماهير الناس من استيعابها؛ إذ لا يصح بحال أن يبقى السواد الأعظم من الناس بعيدين عن المعارف الأساسية والمعارف المعاصرة، ما دمنا نعتقد أن (العلم) هو القاعدة التي سيقوم عليها البناء الحضاري كله.
ـ ترجمة أفضل ما لدى الأمم الأخرى من معارف وعلوم وأفكار وتقنيات، حتى نكتسب ما نحن بحاجة إليه في تحسين مستوى الحياة لدينا، وحتى نعرف ما يدور في العالم من حولنا.
ـ تقديم الاستشارات العلمية للهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية وهذا لن يتم إلا إذا استوعبت الجامعات حاجات القطاعات الصناعية والعمرانية والتجارية من الخبرات والدراسات وعملت على تلبيتها.
ـ عقد الدورات التدريبية والتنشيطية للموظفين - ولا سيما المعلمين - وإقامة الندوات والمحاضرات العامة التي تنشر الوعي بين الناس، وتبصرهم بالحلول لأشكال معاناتهم.
ولن يكون بمقدور الجامعات أن تقوم لهذا كله على نحو جيد ما لم تتم إعادة تنظيمها من جديد من خلال إجراء تغييرات جذرية كثيرة في كل أوضاعها، إلى جانب إعادة رسم أهدافها على نحو أكثر شمولاً ووضوحاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الإدارة: 1: 205.
2ـ مجلة المعرفة: عدد ذي القعدة، عام 1417 هـ، ص 68.
 الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












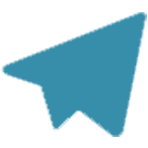
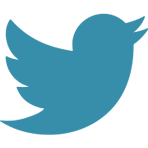

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)