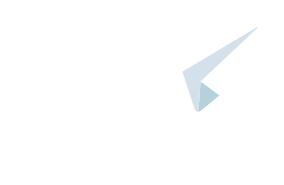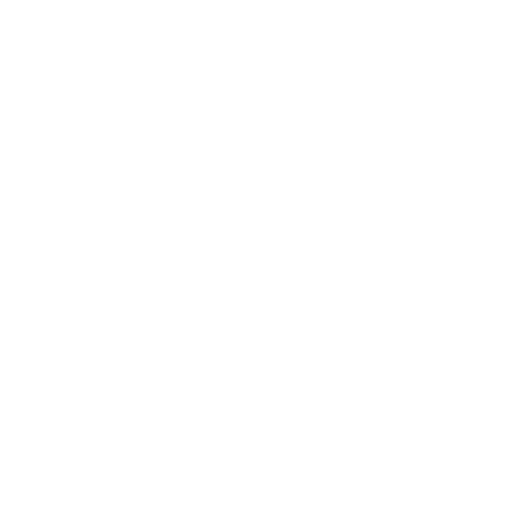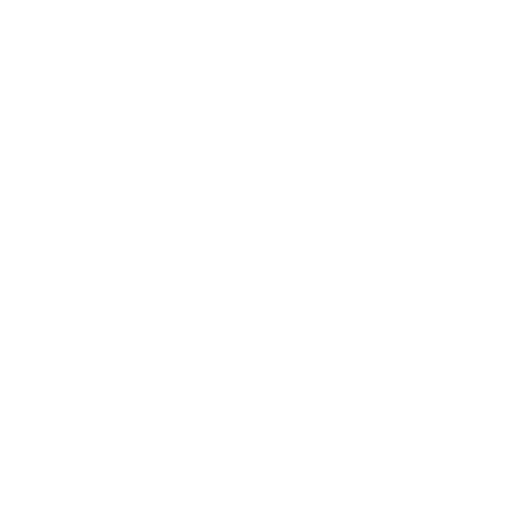تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
الناس مكلّفون بمعرفة إمامهم في كلّ عصر
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الإمام
الجزء والصفحة:
ج3/ص27-35
2025-11-27
377
نجد في الأحاديث الثلاثة المنقولة عن كتاب «الاختصاص» للشيخ المفيد رضوان الله عليه أنَّ الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام يؤكّدان على أنَّ طريق النجاة الوحيد هو معرفة الإمام الحيّ الظاهر. ويرويان عن رسول الله أنَّه قال: «من مات بغير إمام حيّ ظاهر يعرفه ويسمع كلامه، ويسلّم له، ويطيعه، ويتربّى على يديه، فإنَّه مات ميتة أهل الجاهليّة». وهذه مسألة في غاية الصواب، وتستدعي التمعّن والتأمّل كثيراً.
في ضوء ما تقدّم، فإنَّ الأشخاص الذين يعيشون في عصر غيبة الإمام محرومون بلا شكّ من أكثر الفضائل والفواضل. وما عليهم إلّا إعداد المقدّمات لظهور الإمام كي يتخلّصوا من ميتة الجاهليّة، وكذلك يمهّدوا الأرضيّة اللازمة لظهوره من خلال العمل بتعاليم القرآن، والجهاد في سبيل الله، وتآلف القلوب؛ لأنَّ سبب الغيبة هو النقص والفتور الذي عليه الناس، وعدم استعدادهم، وليس سببها نقصاً في الإمام نفسه. ولو تضاءل ذلك النقص، ونشطت القلوب شيئاً فشيئاً، وترسّخت التعاليم القرآنيّة فيها بشكل صحيح، فإنَّ ظهور الإمام سيكون حتميّاً، كما نلاحظ ذلك في رسالة الإمام نفسه إلى الشيخ المفيد رضوان الله عليه حيث ذكَّر بهذه الحقيقة. فهو عليه السلام يقول فيها: «وَلَوْ أنَّ أشْيَاعَنَا- وَفَّقَهُمُ اللهُ لِطَاعَتِهِ- على اجْتِماعٍ مِنَ الْقُلُوبِ في الْوَفَاءِ بِالعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأخَّرَ عَنْهُمُ اليمْنُ بِلِقَائِنَا»[1].
إذاً، يتّضح أنَّ سبب عدم الظهور هو افتراق الآراء وعدم اجتماع القلوب على الوفاء بالعهد الذي قطع معهم. وهذا تقصير عظيم من الشيعة بل من الامّة جميعها. وإنَّ ضروب الحرمان كلّها نحو؛ فقدان الإنصاف وسيادة الظلم والشرك والتعسُّف، مع جميع مظاهر قبحها. منبعثة عن الفتور والارتخاء، وبالتالي تكون علّة لغيبة الإمام.
ولا منافاة بين ما ذكرناه هنا، وبين الحديث المأثور عن رسول الله إذ أخبر فيه جابر بن عبد الله الأنصاريّ، أنَّ شيعته تنتفع به في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلّاها سحاب؛ لأنَّه عليه السلام موجود بنفسه الزكيّة وصدره الرحب وولايته التكوينيّة، غائباً كان أو ظاهراً؛ غاية الأمر ليس له إرشاد ظاهريّ في عصر الغيبة ولا يخضع الناس لتوجيهات الإمام وتعاليمه في سيرهم التكامليّ. وهذا ممّا يبعث على الأسف، والأسف الشديد طبعاً.
وثمّة فارق كبير بين الشمس التي تبسط أشعّتها على الطبيعة، فتكسو الأشجار خضرة، وتمنح الأرض نوراً وحرارة أكثر، وتعقّم الطبيعة بالقضاء على الأمراض والجراثيم، فتستبدلها بالصحّة والسلامة، وتظهر بواطن الأشياء، وبين الشمس المحتجبة خلف السحاب، تملأ السماء ضباباً، وتنغّص على الناس حياتهم بالأجواء الموبوءة بجراثيم الزكام وغيره. أجل، فإنَّ الناس ينتفعون في عصر الغيبة، وينتفعون في عصر الظهور أيضاً، ولكن شتّان بين الاثنين! هذا مع أنَّ بعض الأشخاص القلائل المتحلّين بالهمّة العالية في عصر الغيبة قد دخلوا ميدان العمل بإرادة وطيدة وعزم راسخ ونيّة قويّة، فنالوا إلى حدٍّ ما شرف معرفة الإمام بسبب صفاء قلوبهم وطهارة أرواحهم. وهذا- طبعاً- ظهور شخصيّ لهم، مثلهم بذلك مثل راكب الطائرة في سماء غائمة فيحلّق فوق الغيوم ليصل إلى إشعاعات الشمس المشرقة. لذلك فإنَّ سبيل التكامل في عصر الغيبة غير مسدود أمام التوّاقين إلى حريمه المقدّس. وأيّ فرق بين الظهور والغيبة عند من بلغ مقام المعرفة وأدرك ذلك الوجود المقدّس بحقيقة الولاية والنورانيّة. سُئل أحد الأعاظم: متى يتشرّف الإنسان بالحضور عند الإمام؟
فأجاب: حينما لا يكون هناك فرق بين الغيبة والظهور عند الإنسان.
وسُئل عظيم آخر أيضاً: هل تشرّفت برؤية إمام العصر والزمان؟ فأجاب: عميتْ عينٌ تستيقظ من نومها وقت الصباح، فلا تراه في أوّل نظرتها.
ذكر البرقيّ في كتاب «المحاسن» بإسناده المتّصل عن فضيل، أنَّه قال: سَمِعْتُ أبا جَعْفَرٍ عَلَيهِ السَّلامُ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ ولَيْسَ لَهُ إمَامٌ فَمَوتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، ولَا يُعْذَرُ النَّاسُ حتى يَعْرِفُوا إمَامَهُمْ، ومَن مَاتَ وهُوَ عَارِفٌ لإمَامِهِ لَا يَضُرُّهُ تَقَدَّمَ هَذَا الأمْرُ أوْ تَأخَّرَ، ومَنْ مَاتَ عَارِفاً لإمَامِهِ كَانَ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقَائِمِ في فُسطاطِهِ»[2].
والجهة الاخرى من جهات البحث في الحديث المتواتر عن رسول الله، أنَّ المراد من معرفة الإمام، هو معرفة شخص واحد في كلّ زمان، كما جاء ذلك في حديث جابر، حيث ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله الأئمّة واحداً بعد الآخر. ومجمل القول لو قال أحد: إنَّي أقرّ بآل محمّد، ولم يتّخذ لنفسه إماماً من بين الأئمّة المنصوص عليهم، مثلًا يختار لنفسه محمّد بن الحنفيّة، أو زيد بن عليّ بن الحسين، أو عبد الله بن موسى بن جعفر إماماً فإنَّه يموت ميتة جاهليّة أيضاً.
للأئمّة الطاهرين عليهم السلام خصوصيّات غير متوفّرة للآخرين من ذرّيّة النبيّ من بني الحسن أو بني الحسين. وهذه الميزات الروحيّة وسعة الصدر ومقام الولاية الباطنيّة مواصفات تخصّهم بالذات ومنحصرة بهم ولذلك جاء في الروايات الثلاث التي نقلناها عن غيبة النعمانيّ سابقاً أنَّ الأئمّة الطاهرين يعتبرون كلّ من لا يعتقد بإمامة أحدهم ضالًّا، إذ يقول هذا مثلًا: إنَّ أمر الولاية غير خارج عن آل محمّد، ولكن هم مختلفون فيما بينهم، فإذا اتّفقوا على التسليم لأحد منهم، نقرّ بإمامته أيضاً، فهذا كما يقول الأئمّة إذا مات على هذه النيّة فإنَّ ميتته جاهليّة، حتى لو صلّى ودفع الزكاة واعتبر حلال آل محمّد حلالًا، وحرامهم حراماً؛ لإنَّه لا معنى لاتّفاقهم على تعيين إمام لهم، فتعيين الإمام ليس من صلاحيّة أحد، مضافاً إلى ذلك، أنَّ الإمام لا يستطيع أن يسلّم لأحد، ولو حدث أحياناً أنَّ الآخرين لا يسلّمون للإمام أيضاً، فإمامته في هذه الحالة لا تسقط. ولا يرتفع التكليف بالمعرفة، وحتى لو كان هناك اختلاف بين ذريّة الرسول، فما على الإنسان إلّا البحث عن الإمام الحقيقيّ حتى ينجو من الجاهليّة. وكان بين أصحاب الأئمّة أفراد كثيرون يشكّكون ويتوقّفون في إمامة الإمام الذي يخلف الإمام المتوفى، أو أنَّهم يذهبون إلى إمامة شخص آخر من أبناء أمير المؤمنين، أو أبناء الحسن، أو أبناء سائر الأئمّة، كالكيسانيّة والفَطَحيّة، والناووسيّة، والواقفيّة، والزيديّة، والإسماعيليّة وغيرهم فهؤلاء كلّهم ضالّون ومن ثمّ لم يعتبر الكبار من الأصحاب والعلماء رواياتهم موثوقة كروايات الشيعة.
جاء في آخر كتاب «مدارك الأحكام» الذي يعتبر من الكتب الفقهيّة النفيسة، ضمن ذكره عشرين خبراً منطوياً على بعض الفوائد، قوله: السادس عشر: ما رواه الكلينيّ في الصحيح أيضاً، عن أبي عبيدة [الحذّاء] وزرارة جميعاً، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: «لمّا قُتل الحسين صلوات الله عليه أرسل محمّد بن الحنفيّة إلى عليّ بن الحسين عليه السلام فخلا به، فقال له: يا بن أخي، قد علمت أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله دفع الوصيّة بعده إلى أمير المؤمنين، ثمّ إلى الحسن ثمّ إلى الحسين صلوات الله عليهم، وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلّي على روحه ولم يوصِ، وأنا عمّك وصنو أبيك، وولادتي من علي، وأنا في سنّي وقدمي أحقّ بها منك في حداثتك، فلا تنازعني في الوصيّة والإمامة ولا تحاجّني. فقال له عليّ بن الحسين عليهما السلام: يَا عَمِّ اتَّق اللهَ ولَا تَدَّعِ مَا لَيْسَ لَكَ بِحَقٍّ، إنَّي أعِظُكَ أن تُكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. إنَّ أبي يا عمّ (صلوات الله عليه) أوصى إلى قبل أن يتوجّه إلى العراق، وعهد إلى في ذلك قبل أن يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول الله صلّى الله عليه وآله عندي [وهو علامة الإمامة]، فلا تتعرّض لهذا، فإنّي أخاف عليك نقص العمر وتشتّت الحال. إنَّ الله تبارك وتعالى جعل الوصيّة والإمامة في عقب الحسين عليه السلام. فإن أردتَ أن تعلم ذلك، فانطلق بنا إلى الحَجَر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك».
قال أبو جعفر عليه السلام: وكان الكلام بينهما بمكّة، فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود، فقال عليّ بن الحسين عليه السلام لمحمّد بن الحنفيّة: ابدأ أنتَ وابتهلْ إلى الله عزّ وجلّ وسَلْ [سَلْه] أن ينطق لك الحجر ثمّ سله. فابتهل محمّد بن الحنفيّة في الدعاء، وسأل الله عزّ وجلّ ثمّ دعا الحَجَر فلم يُجبه، فقال عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما: يا عمّ، لو كنتَ وصيّاً وإماماً لأجابك. قال له محمّد: فادع أنتَ يا بن أخي وسله. فدعا الله عزّ وجلّ عليّ بن الحسين عليه السلام بما أراد. ثمّ قال: أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الخلق أجمعين لما أخبرتنا مَن الوصيّ والإمام بعد الحسين بن عليّ عليهما السلام قال: فتحرّك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه، ثمّ أنطقه الله عزّ وجلّ بلسان عربيّ مبين فقال: إنَّ الوصيّة والإمامة بعد الحسين بن عليّ عليهما السلام إلى عليّ بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. قال: فانصرف محمّد بن عليّ وهو يتولّى عليّ بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين»[3].
أجل، فللإمام مواصفات خاصّة لا يتحلّى بها غيره حتى لو كان عمره أقلّ من الآخرين. فإنَّ حبّة الدّر مع أنَّها ثمينة، بَيدَ أنَّها لا تقاس بحبّة ألماس وربّما كان لحبّة ألماس قيمة تفوق قيمة حبّة الدرّ آلاف المرّات. إنَّ العقيق اليماني والعقيق الهنديّ كلاهما عقيق، ولكن شتّان بينهما! وإنَّ لمحمّد بن الحنفيّة وزيد بن عليّ بن الحسين مقامات سامية وسوابقَ طيّبة وأفكاراً عالية، بَيدَ أنَّهما لا يقاسان أبداً بالأئمّة ومقاماتهم ودرجاتهم. وكان عليّ بن جعفر رجلًا عالماً ومحدّثاً وخبيراً وراوياً وفقيهاً وزاهداً، وكان من كبار بني هاشم، وبني الزهراء، وأبناء سيّد الشهداء عليه السلام وعمّ الإمام الرضا والد الإمام الجواد، وكان في سنّ الشيخوخة، وأقرّ مع جميع ما يتمتّع به من مواصفات بإمامة طفل له من العمر سبع سنين «الإمام الجواد»، وسلّم له خاضعاً، ولم يأل جهداً في توقيره وتعظيمه، واستفاد من علمه كثيراً. وكان ميثم تمّاراً عنده عدد من سلال التمر في مكان قريب من مسجد الكوفة، بَيدَ أنَّه حصل من المقام والمنزلة نتيجة تسليمه للإمام أمير المؤمنين وطاعته له ما جعله يعرف الإمام النورانيّة والولاية. وكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يذهب إلى دكّانه بعض الوقت. فكانا يجلسان مستأنسين كالأخوين الشفيقين. وعلّمه الإمام من الأسرار الغيبيّة والمعارف الإلهيّة ما أذهل كلّ ناظر لهما.
وكان ابن عبّاس تلميذ مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أستاذاً في التفسير، ومن القادة العسكريّين المشهورين، ومن خواصّ الإمام. وكان محمّد بن الحنفيّة يخاطبه بربّانيّ الامّة، بَيدَ أنَّه لم يتحمّل العلوم التي كانت عند ميثم التمّار. ولم يستوعبها، إذ كان ذلك الرجل التمّار على درجة من معرفة إمامه لم تتيسّر لابن عبّاس، فأحياناً كان ابن عبّاس يأمر الإمام أو يؤاخذه على بعض الأعمال.
ذات يوم قال الإمام لميثم: «كيف أنت إذا طلبك دعيّ[4] بني أميّة وأمرك بالبراءة منّي؟» فقال ميثم: لا والله، لا أتبرّأ منك. فقال الإمام: «والله، سيقتلونك ويصلبونك». فقال ميثم: أصبر، وهذا قليل يهون في سبيل الله، فقال الإمام: «ستكون معي وفي درجتي يوم القيامة». فهذا التلميذ عارف بإمامه، مدرك لسيطرته الغيبيّة على المُلك والملكوت. ولذلك كان يخبر بالمغيبات وما يُخبِئهُ المستقبل من فِتَن وأحداث. وكانت وقائع المستقبل كلّها واضحة ومشهودة أمامه كالمرآة، فكيف بالإمام نفسه الذي كان يخبر صاحبه بالأسرار والمَغيّبات، والذي أقرّ الصديق والعدوّ بعلومه الغيبيّة.
يقول ابن حجر الهيثميّ: وسُئِلَ وهُوَ على الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ عَنْ قَولِهِ تعالى: {رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ ومِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}[5] فَقَالَ: «اللَّهُمَّ غَفْراً! هَذِهِ الآياتُ نَزَلَتْ فِيّ وفي عَمِّي حَمْزَةَ وفي ابْنِ عَمِّي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْد الْمُطَّلِبِ، فَأمَّا عُبَيْدَةُ فَقَضَى نَحْبَهُ شَهيداً يَوْمَ بَدْرٍ، وحَمْزَةُ قَضَى نَحْبَهُ شَهيداً يَوْمَ احُدٍ، وأمّا أنَا فَأنْتَظِرُ أشقَاهَا يَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ- وأشارَ بِيَدِهِ إلى لِحْيَتِهِ ورَأسِهِ- عَهْدٌ عَهِدَهُ إلى حَبِيبي أبُو الْقَاسِمِ صلّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ»[6].
وَرُويَ أنَّ عَلِيّاً جَاءَهُ ابنُ مُلجَم يَستَحمِلُهُ[7] فَحَمَلَهُ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
ارِيدُ حَيَاتَهُ ويُرِيدُ قَتْلِي *** عَذِيري[8] مِنْ خَلِيلِي مِن مُرادِ
ثُمَّ قالَ: «هَذَا واللهِ قَاتِلِي»، فَقِيلَ لَهُ: ألَا تَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «فَمَنْ يَقْتُلُنِي؟!»[9]
[1] «الاحتجاج» للشيخ الطبرسيّ، ج 2، ص 325.
[2]«بحار الأنوار» ج 7، ص 17.
[3] «مدارك الأحكام» ص 461 وص 462، و«إثبات الهداة» ج 5، ص 218.
[4] جاء في عبارة الإمام: ليأخذنّك العتلّ الزنيم دعيّ بني اميّة. والدعيّ هو الابن المتبنّى، أو المتّهم في نسبه.
[5] الآية 23، من السورة 33: الأحزاب.
[6] «الصواعق المحرقة» ص 80، و«نور الأبصار» للشبلنجيّ ص 97.
[7] يستحمله يعني يسأل الإمام أن يحمله على فرسه. والشاهد على هذا المعنى رواية واردة في طبقات ابن سعد. يقول المرحوم المجلسيّ في ج 9، من «بحار الأنوار» ص 647: وذكر ابن سعد في «الطبقات» أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام، لما جاء ابن ملجم وطلب منه البيعة، طلب منه فرساً أشقر فحمله عليه فركبه، فأنشد أمير المؤمنين عليه السلام: اريدُ حياته- البيت.
[8] كر ابن الأثير في «النهاية» عذيرك من خليلك من مراد وقال: عذير بمعنى اسم الفاعل، أي: عاذر. ويقال: عاذر لمن يقبل العذر. و «عذيرَك» منصوب بفعل مقدّر «أي هاك عذيرَك». ولذلك فلا فرق بين عذيرك وعذيري. والمراد من كاف الخطاب المتكلّم نفسه. ونسب هذا الشعر إلى أمير المؤمنين عليه السلام نفسه، وليس تمثّلًا. وجاء في بعض النسخ «حِباءه» بدلًا عن «حياته».
[9] «الصواعق المحرقة» ص 80.
 الاكثر قراءة في الامامة
الاكثر قراءة في الامامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












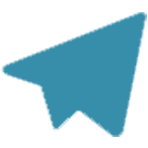
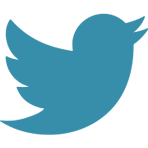

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)