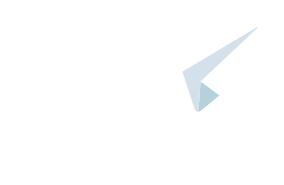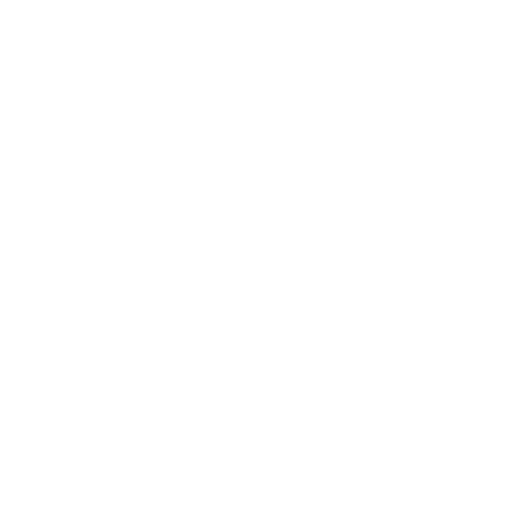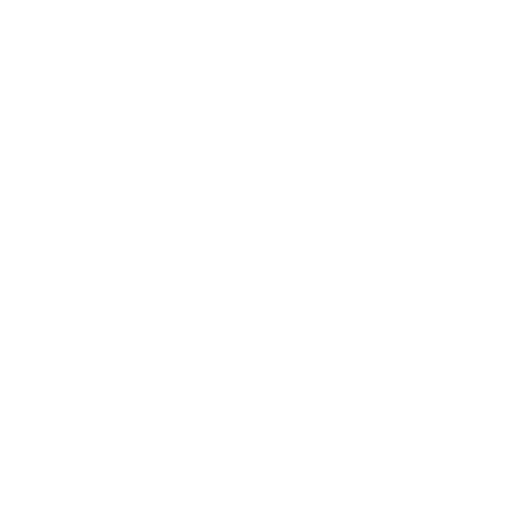تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
دراسة لغوية لمعنى الولاية
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الإمام
الجزء والصفحة:
ج5/ص3-20
2025-12-15
385
قال الله الحكيم في كتابه الكريم: {هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وخَيْرٌ عُقْباً}.[1]
جاءت كلمة الولاية- مصدراً كانت أو اسم مصدر- في القرآن المجيد وغيره بمشتقّات كثيرة نحو: الوليّ، وتَوَلّى، ووَالى، وأوْلِياء، ومَوالى، ومُوَلِّى، وتوليّ، وتَوْلِيَةْ، وغيرها من المشتقّات.
والآن ينبغي لنا أن نرى ما هو المعنى اللغويّ للولاية، ثمّ نتحدّث عن تفسير الآية المباركة.
أما معنى الكلمة لغويّاً، فهو كما يلي: يقول في «المصباح المنير»: الْوَلْيُ مِثْلُ فَلْسِ: الْقُرْبُ. وفي الفعل لغتان [أكثرهما] وَلِيَهُ يَلِيهِ بكسرتين [من باب حَسِبَ- يَحْسِبُ]؛ والثانية من باب وَعَدَ [يَعِدُ]، وهي قليلة الاستعمال ... ووَلِيتُ على الصَّبِيّ والْمَرْأةِ فالفاعل والٍ والجمعُ وُلَاةٌ. والصبيّ والمرأة مَوْلِيّ عَلَيْهِ ... والوِلَايَةُ بالفتح والكسر النُّصْرَةُ. واسْتَوْلَى عَلَيْهِ غلب عليه وتمكّن منه.
وجاء في «صِحاح اللغة»: الْوَلْيُ- القرب والدنوّ. يقال: تباعَدَ بَعْدَ وَلْيٍ؛ وكُلْ مِمّا يَليكَ، أي: مِمّا يُقَاربُكَ؛ إلى أن يقول: والوَلِيّ ضدّ العدو، يقال منه تولّوه. والمَوْلَى المعتِق، ولمعتَق، وابن العمّ، والناصر، والجار.
والوَليّ الصهر؛ وكُلُّ مَنْ وَلِيَ أمْرَ واحِدٍ فَهُوَ وَلِيُّهُ. إلى أن يقول: والوِلَاية بالكسر السلطان؛ والوِلَاية بالكسر والفتح: النصرة؛ وقال سيبويه: الوَلَاية بالفتح المصدر؛ وبالكسر الاسم مثل: الإمارة والنِقابَة؛ لأنه اسم لما تولّيَته وقمتَ به؛ فإذا أرادوا المصدر فتحوا.
وجاء في «أقرب الموارد»: وَلَاهُ ووَلِيَهُ يَلِيهِ، من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ وحَسِبَ يَحْسِبُ، والأوّل قليل الاستعمال؛ [و المصدر] وَلِي، أي دنا منه وقرب يقال: جَلَسْتُ مِمَّا يَلِيهِ؛ أي يقاربه؛ ويقال: الْوَلِيُ حُصُولُ الثَّانِي بَعْدَ الأوَّلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ.
وَلِى الشَّيءِ وعَلَيْهِ وِلَايَةً ووَلَايَةً: ملك أمره، وقام به. أو الوِلَايَة بالفتح والكسر الخِطَّة والإمارة والسلطان؛ ووَلِى فلَاناً وعَلَيْهِ: نصره، ووَلِى فُلَاناً وَلَايةً: أحبّه؛ ووَلِى الْبَلَدَ: تسلّط عليه.
والوالى اسم فاعل، ومنه: والى البَلَد للمتسلّط عليها وحاكمها، لأنه يلي القوم بالتدبير والأمر والنهي؛ والجمع وُلَاة. والوَلَاءُ كسماء: الملك، والمحبّة، والنصرة، والقرب، والقرابة.
والوَلاءَةُ بالفتح: القرابة، والوَلَايةُ بالفتح: مصدر؛ وهي أيضاً بمعنى البلاد التي يتسلّط عليها الوالى، والجمع: وَلَايَاتٌ.
والوِلَايَةُ بالكسر: الخِطّة، والإمارة والسلطان؛ والبلاد التي يتسلّط عليها الوالى، وهذه مولَّدة.
والوَلِيّ كغنيّ: المطر يسقط بعد المطر، أو المطر بعد الوسمي، والجمع: أوْلِيَةٌ، والنسبة إليه: وَلَويّ. وفي «المصباح»: «الوَلِيّ فعيل بمعني فاعل من ولِيَهُ إذا قام به؛ ومنه: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا}، والجمع: أوْلِيآء؛ قال ابن فارس: كُلُّ مَنْ وَلِى أمْرَ أحَدٍ فَهُوَ وَلِيُّهُ؛ وقد يطلق الوليّ على (المُعْتِق)، و(المُعْتَق)، وابن العمّ، والناصر، وحافظ النسب، والصديق، ذكراً كان أو انثى. وقد يؤنّث بالهاء فيقال: هي وَلِيَّةٌ؛ قال أبو زيد: سمعتُ بعض بني عقيل يقول: هُنَّ وَلِيّاتُ اللهِ وعَدُوّاتُ اللهِ وأوْلِيَاؤُهُ وأعْداؤُهُ.
ويكون الوليّ بمعنى مَفعول في حقّ المطيع فيقال: «الْمُؤمِنُ وَلِيّ اللهِ».
وجاء في «مجمع البحرين»: {أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ}[2] يَعْني: أحَقَّهُمْ بِهِ وأقْرَبَهُمْ مِنْهُ، مِنَ الْوَلِيّ؛ وهُوَ الْقُرْبُ.
وقوله تعالى: {هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ}[3] هي بالفتح: الربوبيّة. يعني: يومئذٍ يتولّون الله ويؤمنون به ويتبرّأون ممّا كانوا يعبدون.
والوَلَاية بالفتح أيضاً: النصرة؛ وبالكسر: الإمارة، مصدر وَلِيتُ؛ ويقال: هما لغتان بمعنى الدولة. وفي «النهاية»: هي بالفتح: المحبّة، وبالكسر: التولية والسلطان. ومثله الوِلاء بالكسر- عن ابن السكّيت.
والوَلِيّ والوالى: وكلّ من ولى أمر أحد فهو وليّه.
والوَلِيّ: هو الذي له النصرة والمعونة.
والوَلِي: الذي يدبّر الأمر. يقال: فُلَانٌ وَلِيّ الْمَرأةِ إذا كان يريد نكاحها.
ووَلِيّ الدم: من كان إليه المطالبة بالقِوَد.
والسلطان وليّ أمر الرعيّة، ومنه قول الكُمَيْت الشاعر في حقّ أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: وقوله تعالى: {إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهُمْ راكِعُونَ}.[4] نزلت في حقّ على (بن أبي طالب) عليه السلام. عند المخالف والمؤالف حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فأومأ إليه بخنصره اليمني، فأخذ السائل الخاتم من خنصره؛ ورواه الثعلبيّ في تفسيره.
قال الشيخ أبو عليّ: والحديث طويل، وفيه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: "اللَهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، ويَسِّرْ لِي أمْرِي، واجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أهْلِي، عَلِيّاً أخِي، اشْدُدْ بِهِ ظَهْرِي".
قال أبو ذر: فوالله ما استتمّ الكلام حتى نزل جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمّد! إقرأ: {إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهُمْ راكِعُونَ}.
قال [أبو على]: المعنى: الذي يتولّى تدبيركم ويلي اموركم، الله ورسوله والذين آمنوا، الذين هذه صفاتهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
قال الشيخ أبو على: قال جار الله[5]: إنّما جيء به على لفظ الجمع- وإن كان السبب فيه رجلًا واحداً- ليرغّب الناس في مثل فعله، ولينبّه أنّ سجيّة المؤمن يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان. ثمّ قال الشيخ أبو عليّ: وأقول: قد اشتهر في اللغة العبارة عن الواحد بلفظ الجمع للتعظيم، فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه (من قِبل جار الله).
فهذه الآية من أوضح الدلائل على صحّة إمامة على (بن أبي طالب) عليه السلام بعد النبيّ (الأكرم) صلّى الله عليه وآله وسلّم بلا فصل.
ونقل أنه اجتمع جماعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في مسجد المدينة، فقال بعضهم لبعض: إن كفرنا بهذه الآية، كفرنا بسائرها! وإن آمنّا، صارت فيما يقول، ولَكِنَّا نَتَوَلّى ولَا نُطِيعُ عَلِيّاً فيما أمَرَ، فَنَزَلَتْ: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها}.
وقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنها نزلت في الإمرة. يعني في الإمارة أي: هو صلّى الله عليه وآله وسلّم أحقّ بهم من أنفسهم حتى لو احتاج إلى مملوك لأحد هو محتاج إليه، جاز أخذه منه.
ومنه الحديث: "النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أولى بكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وكَذَا عليّ مِنْ بَعْدِهِ".
وقوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ}.[6] الوليّ ما يقوم مقامه في امور تختصّ به لعجزه، كوليّ الطفل والمجنون.
[وبناءً على هذا] فيلزم أن يكون محتاجاً إلى الوليّ، وهو محال لكونه غنيّاً مطلقاً.
وأيضاً إن كان الوليّ محتاجاً إليه تعالى لزم الدور المحال، وإلّا كان مشاركاً له [و كلاهما محال].
وقوله تعالى {أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} أي: أنت تتولّى أمري في الأولى والعُقبى، وأنت القائم به.
وقوله تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ}[7].
قال الصادق عليه السلام: "يَعْنِي مِنْ ظُلُمَاتِ الذُّنُوبِ إلى نُورِ التَّوْبَةِ والْمَغْفِرَةِ لِولَايَتِهمْ كُلَّ إمامٍ عادِلٍ مِنَ اللهِ".
{وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ}[8].
قال: «إنّما عنى بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام، فلمّا تولّوا كلّ إمام جائر ليس من الله، خرجوا بولايتهم إيّاه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر، فأوجب لهم النار مع الكفّار».
وجاء في «النهاية» لابن الأثير قوله: «في أسماء الله تعالى الولِيّ، وهو الناصر. وقيل: المتولّي لُامور العالم والخلائق القائم بها.
ومن أسمائه عزّ وجلّ الوالى، وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها. والوِلَاية تشعر بالتدبير والقدرة والفِعل. وما لم يجتمع ذلك فيها، لم ينطلق عليها اسم الوالى [إلى أن يقول:]
وقد تكرّر ذكر المَوْلَى في الحديث: وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرَّبُّ، والمالِكُ، والسَيِّد، والمنْعِم، والمُعْتِق، والناصِر، والمُحِبّ، والتابع، والجار، وابنُ العَمّ، والحَلِيف، والعَقيد، والصِهْر، والعَبد، والمُعْتَق، والمُنْعَمُ عَلَيْهِ، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كلّ واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه.
وكلّ من ولى أمراً أو قام به فهو مَوْلَاهُ ووَلِيُّهُ.
وقد تختلف مصادر هذه الأسماء. فالوَلَاية بالفتح في النَّسَب، والنُّصْرَةَ، والمُعْتِق. والوِلَاية بالكسر في الإمارَةَ، والمُعْتَق. والمُوالاة من الفعل وإلى الْقَوْمَ. ومنه الحديث [عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم]: "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيّ مَوْلَاهُ". ويحمل [المَوْلَى في هذا الحديث] على أكثر الأسماء المذكورة.
قال الشافعيّ: يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله تعالى: {ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ}.
وقول عمر لعلى بن أبي طالب:أصْبَحْتَ مَوْلَى كُلِّ مَؤْمِنٍ، أي وَلِيّ كُلِّ مُؤْمِنٍ.
وقيل: سبب ذلك أنّ اسامَةَ قال لعلى: لَسْتَ مولاي، إنَّما مولاي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآلِهِ وسَلَّمَ! فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ: "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيّ مَوْلَاهُ".
وذكر الزمخشريّ في «أساس البلاغة» هذا الكلام نفسه، أعني أنه تحدّث حول الوليْ، والوَلَاءَ، والوَلِي، والمَوْلَى.
وجاء في «تاج العروس»: للوَلِيّ معان كثيرة منها: المُحِبّ؛ وهو ضدّ العدوّ؛ اسم من وَالاهُ إذا أحبّه. ومنها: الصديق، ومنها: النصير من وَالاهُ إذا نصره.
و(وَلِى الشَّيء) ووَلِيَ (عَلَيْهِ وِلَايَةً ووَلَايَةً) بالكسر والفتح؛ أو هي، أي: بالفتح، المصدر؛ وبالكسر: الاسم، مثل: الإمارة، والنِقابَةَ؛ لأنه اسم لما تولّيته وقمت به. فإذا أرادوا المصدر فتحوا، هذا نصّ سيبويه.
وقيل: الوِلَاية بالكسر: الخِطَّةُ، والإمارَة. ونصّ «المُحْكَم» كالإمارة. قال ابن السكّيت: الوِلَاية بالكسر: السلطان.
وبعد أن يذكر معاني متنوّعة للمَوْلَى كما قلنا، يقول: المَوْلَى وكذلك الوليّ: الذي يَلَي عَلَيْكَ أمْرَكَ. وهما [المَوْلَي والوَلِيّ] بمعنى واحد. ومنه الحديث: "أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا". ورواه بعضهم: بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا.
وروى ابن سلام عن يونس أنه قال: انّ المَوْلَى في الدِّينِ هُوَ الْوَلِيّ؛ وذلك قوله تعالى: {ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ}. أي: لَا وَلِيّ لَهُمْ. ومنه الحديث: "مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ"؛ أي: مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ.
إلى أن يقول: [و من معاني الوليّ التي جاءت في أسمائه تعالى]: الناصر. وقيل: الْمُتَوَلِّي لُامُورِ الْعَالَمِ الْقَائِمُ بِهَا. وقيل: معنى الوَلِيّ هنا الوالى، وهُوَ مالِكُ الأشْيَاءِ جَميعها الْمُتَصَرِّفُ فِيها.
وقال ابن الأثير: وكأنّ الوَلَاية تشعر بالتدبير، والقدرة، والفِعل، وما لم يجتمع فيها ذلك، لم يطلق عليها اسم الوالى.
ويقال: وَلِيّ اليتِيم لمن يقوم بشؤونه ويتكفّله؛ ووَلِيّ المرأة لمن يجري نكاحها بإشرافه ولا يقبل أن تنكح بإذنها وبدون إرادته؛ وجمع الوَلِيّ: أوْلِيَآءِ.
الوَلِيّ أو فعيل بمعنى الفاعل؛ أي: من توالت وتتابعت طاعاته لله دون أن يفصل بينها معصية وإثم؛ أو بمعنى المفعول، أي: من انصبّت عليه نعم الله متوالية متتابعة بلا فصل.
وذكر «لسان العرب» ما نقلناه بذاته هنا عن «النهاية» لابن الأثير، وعن «تاج العروس»، لذلك نتجنّب تكراره هنا.
ويقول الراغب الإصفهانيّ في «المفردات» الْوَلاءُ والتَّوالى أنْ يَحْصُلَ شَيْئانِ فَصَاعِداً حُصُولًا لَيْسَ بَيْنَهُما ما لَيْسَ مِنْهُمَا.
ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النِّسبة، ومن حيث الدِّين، ومن حيث الصَّداقة، والنُّصرة، والاعتقاد.
والوِلَاية (بالكسر): النُّصْرَة؛ والوَلَاية (بالفتح): تولّي الأمر؛ وقيل: الوِلَاية، والوَلَاية نحو الدِّلالة والدَّلالة، وحقيقته تَولِّي الأمر.
والوَلِيّ والمَوْلَى يستعملان في ذلك كلُّ واحد منهما يُقال في معنى الفاعل، أي: المُوالى، وفي معنى المفعول، أي، المُوالى.
يقال للمؤمن: هُوَ وَلِيّ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، ولم يَرِدْ مَوْلَاهُ؛ وقد يُقال: اللهُ تعالى وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ ومَوْلَاهُمْ.
فمن الأوّل (يعني معنى الفاعل) قال الله تعالى: 1- {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا}. 2- {إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ} 3- {وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ}. 4- {ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا}. 5- {نِعْمَ الْمَوْلى ونِعْمَ النَّصِيرُ}. 6-{ واعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى.} 7- {قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ}. 8- {وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ}. 9- {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ}.
والوالى الذي في قوله: ومَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن والٍ بمعنى الوليّ.
ثمّ ذكر الراغب كثيراً من الآيات القرآنيّة التي جاء فيها اسم الولي، ونفت الولاية عن غير الله، ونهت عن اتّخاذ اليهود والنصارى أوليآء، واتّخاذ أعداء الله أوليآء. ونقل كثيراً من الآيات التي وردت فيها مشتقّات هذه المادّة مع معانيها المناسبة.[9]
حقّاً فقد نقلنا هنا ما كان ضروريّاً من كتب اللغة حول معنى الولاية ومشتقّاتها لكي يطّلع الخبير البصير على خصوصيّات المعاني ومواضع استعمالها. ويستوعبها بالتدبير والتأمّل، ويفهم أنّ هذه المعاني المتنوّعة للولاية، والوَليّ، والمَوْلَى وغيرها جميعها- حيث قال في «تاج العروس» بأنّ للوليّ واحداً وعشرين معنى- تحوم حول معنى واحد هو أصل معنى الولاية وجذره، ونقلت المعاني الأخرى أيضاً مستعارة من ذلك المعنى؛ أو أنّ أصل معنى الولاية في هذه المواضع جميعها محفوظ؛ وغاية الأمر إنّهم لاحظوا- لسبب من الأسباب- المعنى الأصليّ بانضمام خصوصيّة أخذوها بنظر الاعتبار في الاستعمال.
وأصل ذلك المعنى هو الذي أتى به الراغب في «المفردات» حيث قال في مادّة وَلْي. الْوَلَاءُ والتَّوالى أنْ يَحْصُلَ شَيئانِ فَصَاعِداً حُصُولًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَا لَيْسَ مِنْهُمَا. أي: لا حجاب، ولا مانع، ولا فصل، ولا افتراق، ولا غيريّة، ولا بينونة بينهما بحيث لو فرضنا وجود شيء بينهما فهو منهما؛ لا من غيرهما.
مثلًا، يسمّون مقام الوحدانيّة بين العبد وربّه حيث لا حجاب في أيّ مرحلة من مراحل الطبع، والمثال، والنفس، والروح، والسرّ: ولايةً.
ويسمّون مقام الوحدة بين الحبيب والمحبوب، والعاشق والمعشوق، والذاكر والمذكور، والطالب والمطلوب حين ينعدم أيّ انفصال بينهما بأيّ وجه من الوجوه: ولاية.
وفي ضوء ذلك، فإنّ الله تعالى وليّ الكائنات جميعها في عالم التكوين بشكل مطلق. وإنّ الكائنات جميعها أيضاً وبلا استثناء وليّة الله تكويناً؛ لأنه لا حجاب بين الله الربّ وبين المربوبين إلّا أن يكون ذلك الحجاب منهما؛ وأمّا في عالم التشريع والعرفان، فإنّ ولاية الحقّ تخصّ الذين اجتازوا مراحل الشرك الخفيّ تماماً، واخترقوا الحجب النفسانيّة كلّها، وقرّ قرارهم في النقطة الأصليّة وحقيقة العبوديّة.
وبهذا الميزان يقال لكلّ واحد من طرفي النسبة والإضافة: وليّ، أيّ: زالت البينونة والغيريّة تماماً، وظهرت هُوَ الْهوِيَّة.
هذه هي حقيقة الولاية؛ ومن هنا نرى: أوّلًا: أنّ جميع آثار وخصوصيّات الوليّ بمعنى الفاعل مشهودة في الوليّ بمعنى المفعول، وكالمرآة تعكس وجه صاحب الصورة كلّه دون أدنى حبّ للظهور.
وثانياً: أنّ جميع المشتقّات المنبثقة عن الوليّ، وجميع المعاني المذكورة لهذه الكلمة ترتكز على هذا الأساس، وتقوم على هذا الميزان؛ وذلك لأنّ شرط الولاية هو القُرب. وللقرب أشكال متنوّعة، حيث لوحظت حقيقة الولاية تلك في كلّ مظهر من مظاهر القرب، بكلّ ما للكلمة من معنى، مع ملاحظة هذه الخصوصيّة.
وعلى هذا لا يصحّ أن نقول بأنّ الوَلاية، والوَلِيّ، والمَوْلَى وما يتفرّع عنها من مشتقّات تستعمل في معانٍ متنوّعة هي على نحو الاشتراك اللفظي، لا، فالأمر ليس كذلك، بل هي على نحو الاشتراك المعنويّ واستعمال اللفظ في ذلك المعنى الواحد، حيث اخذ بنظر الاعتبار نوع من خصوصيّة القرب من ذلك المعنى العامّ بواسطة قرينة حالية أو لفظيّة. وهذا اللون من الاستعمال حقيقيّ في جميع موارد الاستعمال.
وفي ضوء هذا الكلام، فإنّنا حيثما وجدنا مفردات الوَلاية، أو الوَليّ، أو المَوْلَى وغيرها، وليست معها قرينة تدلّ على خصوص أحد مصاديقها، فلا مناص لنا أن نأخذ بعين الاعتبار المعنى العامّ دون أيّ قيد، فنعتبره المراد من تلك المفردات. فمثلًا لو قيل: الولاية لله، فلا بدّ أن نقول: أنّ المراد هو معيّة الله لجميع الكائنات. ولو قيل: بلغ فلان مقامَ الوَلاية، فلا بدّ أن نقول: إنّه بلغ مرحلة من مراحل السير والسلوك والعرفان والشهود الإلهيّ زال معها كلّ حجاب من الحجب النفسانيّة بينه وبين الحقّ جلّ شأنه، واضمحلّت شوائب الفرعونيّة والربوبيّة كلّها في وجوده، وظفر بمقام العبوديّة المطلقة المجرّدة للحقّ جلّ وعزّ.
ويتّضح في ضوء هذا الكلام الذي ذكرناه أنه حيثما استعملت الوَلاية، أو الوَلِيّ، فإنّ هناك لوناً من الاتّحاد والوحدة قائم بين شيئين، وقد أتوا بهذه المفردة في ضوء ذلك الأصل. فهناك مثلًا نسبة بين المالِك والمَمْلُوك، وهذه النسبة قد ربطتهما وشدّت أحدهما بالآخر، لذا يقال لكلّ واحد منهما: وليّ. وكذلك النسبة بين السيّد وعبده، والنسبة بين المُنْعِمِ والمُنْعَمِ عليه. فإنّها جعلتهما تحت عنوان خاصّ، حيث يقال لكلّ واحد من هذين الاثنين: وليّ. والنسبة الموجودة بين المُعتِق والمُعتَق أتت بهذا العنوان تالياً لها. وهكذا النسبة القائمة بين الحليفين، والعقيدين، وبين الحَبيب والمُحِبّ.
ويسمّى الصِهْرُ وَلِيّاً لأنه يعتبر أحد أفراد الأسرة في كثير من شئونها بسبب القرابة الحاصلة من وراء مصاهرته؛ ويسمّى الجارُ وَلِيّاً لأنّ له أحكاماً واحترامات خاصّة بسبب القرب المكانيّ؛ ويسمّى ابْنُ العَمِّ وَلِيّاً لأنه أحد أفراد العاقلة، وتقع عليه دية الخطأ، وله في كثير من الحالات حكم الأخ، والمعين.
وحيثما كانت هناك قرينة خاصّة لإرادة أحد المعاني، فينبغي أن نحمل اللفظ عليه، وإلّا تبادر إلى الذهن معنى الولاية العامّة بلا قرينة؛ وكان ذلك المعنى هو مراد المتكلّم. ومن المعلوم أنّ المالكيّة في التدبير، وولاية الأمر، والقيام بمسائل المولّى عليه نتائج متمخّضة عن الولاية، وليست أصل حقيقتها ومعناها المطابق لها، وحيثما لوحظ أنهم فسّروا الولاية أحياناً بالحكومة، والإمارة، والسلطان، والمراقبة والحراسة، فإنّما كان تفسيراً بلوازم المعنى، لا تبياناً للمعنى الحقيقيّ.
على هذه الوتيرة، فإنّ سماحة العلامة الطباطبائي قال في رسالة «الوِلَايَة» وفي تفسير «الميزان»: الْوَلَاية هِيَ الْكَمالُ الأخيرُ الْحَقِيقِيّ لِلإنْسَانِ وإنَّهَا الْغَرَضُ الأخِيرُ مِنْ تَشْرِيعِ الشَّرِيعَةِ الْحَقَّةِ الإلَهيَّةِ.
وقال في التفسير: والولاية وإن ذكروا لها معانٍ كثيرة، لكِنَّ الأصْلَ في مَعْنَاهَا ارْتِفَاعُ الْوَاسِطَةِ الْحَائِلَةِ بَيْنَ الشَّيْئَينِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَا لَيْسَ مِنْهُمَا. ثمّ استعيرت لقرب الشيء من الشيء بوجه من وجوه القرب كالقرب نسباً، أو مكاناً، أو منزلة، أو بصداقة، أو غير ذلك.
ولذلك يطلق الوليّ على كلّ من طرفي الولاية، وخاصّة بالنظر إلى أنّ كلّا منهما يلي من الآخر ما لا يليه غيره. فالله سبحانه وَلِيّ عبده المؤمن، لأنه يلي أمره، ويدبّر شأنه فيهديه إلى صراطه المستقيم، ويأمره وينهاه فيما ينبغي له أو لا ينبغي، وينصره في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
والمؤمن حقّاً وَلِيّ ربّه لأنه يلي منه إطاعته في أمره ونهيه، ويلي منه عامّة البركات المعنويّة من هداية، وتوفيق، وتأييد وتسديد، وما يعقّبها من الإكرام بالجنّة والرضوان.
فأولياء الله- على أيّ حال- هم المؤمنون، فإنّ الله يعدّ نفسه وليّاً لهم في حياتهم المعنويّة، حيث يقول: {وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ}.[10]
غير أنّ الآية التالية لهذه الآية: {أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ}.و هي قوله: {الَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَّقُونَ} المفسّرة لقوله: أوليآء الله، تأبي أن تكون الولاية شاملة لجميع المؤمنين، وفيهم أمثال الذين يقول الله سبحانه فيهم: {وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وهُمْ مُشْرِكُونَ}.[11]
فإنّ قوله في الآية التالية: {الَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَّقُونَ} يعرّفهم بالإيمان والتقوى مع الدلالة على كونهم على تقوى مستمرّة سابقة على إيمانهم من حيث الزمان؛ حيث قيل: ءَامَنُوا ثمّ قيل عطفاً عليه: وكَانُوا يَتَّقُونَ.
فدلّ على أنهم كانوا يستمرّون على التقوى قبل تحقّق هذا الإيمان منهم. ومن المعلوم أنّ الإيمان الابتدائيّ غير مسبوق بالتقوى، بل هما متقاربان أو هو قبل التقوى، وخاصّة التقوى المستمرّة؛ فالمراد بهذا الإيمان مرتبة اخرى من مراتب الإيمان غير المرتبة الاولى منه. فقد تقدّم في الجزء الأوّل من الكتاب آية 130 من سورة البقرة أنّ لكلّ من الإيمان والإسلام، وكذا الشِّرك والكُفر مراتب مختلفة بعضها فوق بعض.
فالمرتبة الاولى من الإسلام إجراء الشهادتين لساناً والتسليم ظاهراً؛ وتليه المرتبة الاولى من الإيمان، وهو الإذعان بمؤدّى الشهادتين قلباً إجمالًا، وإن لم يسر إلى جميع ما يعتقد في الدين من الاعتقاد الحقّ.
ولذا كان من الجائز أن يجتمع مع الشرك من بعض الجهات، قال تعالى: {وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وهُمْ مُشْرِكُونَ}.
ولا يزال إسلام العبد يصفو وينمو حتى يستوعب تسليمه لله سبحانه في كلّ ما يرجع إليه، وإليه مصير كلّ أمر.
وكلّما ارتفع الإسلام درجة ورقي مرتبة، كان الإيمان المناسب له الإذعان بلوازم تلك المرتبة حتى يسلم العبد لربّه حقيقة معنى إلوهيّته، وينقطع عنه السخط والاعتراض، فلا يسخط لشيء من أمره، من قضاء وقدر وحكم، ولا يعترض على شيء من إرادته، وبإزاء ذلك الإيمان اليقين بالله وجميع ما يرجع إليه من أمر، وهو الإيمان الكامل الذي تتمّ به للعبد عبوديّته.
قال تعالى:{فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}.[12]
والأشبه أن تكون هذه المرتبة من الإيمان أو ما يقرب منه هو المراد بالآية، أعني: قوله: {الَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَّقُونَ} فإنّه الإيمان المسبوق بتقوى مستمرّة دون الإيمان بمرتبته الاولى كما تقدّم.
على أنّ توصيفه أهل هذا الإيمان بأنهم {لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ}. يدلّ على أنّ المراد منه الدرجة العالية من الإيمان الذي يتمّ معه معنى العبوديّة والمملوكيّة المحضة للعبد الذي يرى معه أنّ الملك لله وحده لا شريك له، وأن ليس إليه من الأمر شيء حتى يخاف فوته أو يحزن لفقده.
وذلك أنّ الخوف إنّما يعرض للنفس عن توقّع ضرر يعود إليها، والحزن إنما يطرأ عليها لفقد ما تحبه أو تحقّق ما تكرهه ممّا يعود إليها نفعه أو ضرره. ولا يستقيم تحقّق ذلك إلّا فيما يرى الإنسان لنفسه ملكاً أو حقّاً متعلّقاً بما يخاف عليه أو يحزن لفقده من ولد أو مال أو جاه أو غير ذلك.
وأمّا ما لا علاقة للإنسان به بوجه من الوجوه أصلًا، فلا يخاف الإنسان عليه، ولا يحزن لفقده البته.
والذي يرى كلّ شيء ملكاً طلقاً لله سبحانه لا يشاركه في ملكه أحد، لا يرى لنفسه ملكاً أو حقّاً بالنسبة إلى شيء حتى يخاف في أمره أو يحزن.
وهذا هو الذي يصفه الله من أوليائه، إذ يقول: {أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ}.
فهؤلاء لا يخافون شيئاً ولا يحزنون لشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة إلّا أن يشاء الله، وقد شاء أن يخافوا من ربّهم وأن يحزنوا لما فاتهم من كرامته إن فاتهم. وهذا كلّه من التسليم لله.
وبعد بحث بليغ لسماحة العلّامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه حول اتّصاف أوليآء الله بعدم الخوف وعدم الحزن، وأنّ القرائن تفيد بأنّ هاتين الصفتين تتحقّقان لهم في هذه الدنيا، وأنّ الآية تبيّن أحوالهم فيها، يقول في ختام بحثه:
والآية تدلّ على أنّ هذا الوصف إنّما هو لطائفة خاصّة من المؤمنين يمتازون عن غيرهم بمرتبة خاصّة من الإيمان تخصّهم دون غيرهم من عامّة المؤمنين، وذلك بما يفسّرها من قوله: {الَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَّقُونَ} بما تقدّم من تقرير دلالته.
وبالجملة فارتفاع الخوف من غير الله والحزن عن الأولياء ليس معناه أنّ الخير والشرّ، والضرر والنجاة والهلاك، والراحة والعناء، واللذّة والألم، والنعمة والبلاء متساوية عندهم ومتشابهة في إدراكهم، فإنّ العقل الإنساني، بل الشعور العامّ الحيوانيّ لا يقبل ذلك. بل معناه أنهم لا يرون لغيره تعالى استقلالًا في التأثير أصلًا، ويقصرون الملك والحكم فيه تعالى فلا يخافون إلّا إيّاه أو ما يحبّ الله ويريد أن يحذروا منه أو يحزنوا عليه.
إنّ التوحيد الكامل يقصر حقيقة الملك في الله سبحانه، فلا يبقى لغيره شيء من الاستقلال في التأثير حتى يتعلّق به لنفسه حبّ أو بغض، أو خوف أو حزن، أو فرح أو أسى، أو غير ذلك.
وإنّما يخاف هذا الذي غشيه التوحيد ويحزن أو يحبّ أو يكره بالله سبحانه ويرتفع التناقض حينئذٍ بين قولنا: إنّه لا يخاف شيئاً إلّا الله، وبين قولنا: إنّه يخاف كثيراً ممّا يضرّه ويحذر اموراً يكرهها، فافهم ذلك.[13]
وذكر صاحب تفسير «بيان السعادة» أيضاً مجملًا للتفصيل الذي أتى به العلّامة في ذيل الآية: {هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِ} حول معنى الولاية، وقال:
الوَلَاية بالفتح: والتصرّف والنصرة والتربية؛ وبالكسر: السلطنة والإمارة؛ وقرئ بهما [بالفتح والكسر] وهُنَالِكَ اسم إشارة يشار به إلى المكان؛ والمراد به مرتبة من النفس لتشبيهها بالمكان؛ يعني في تلك الحال التي ينقطع آمال النفس من كلّ ما سوى الله، يظهر لها أنّ الولاية لله، الذي يظهر أنه كان حقّاً لا غير. لذلك كانت ولايته باقية وولاية غيره باطلة.
إذن، ففائدة التوصيف الإشعار بظهور كونه تعالى حقّاً حينئذٍ وكون غيره باطلًا.[14]
[1] الآية 44، من السورة 18: الكهف.
[2] الآية 68، من السورة 3: آل عمران.
[3] الآية 44، من السورة 18: الكهف.
[4] الآية 55، من السورة 5: المائدة.
[5] جار الله لقب الزمخشريّ صاحب تفسير «الكشّاف» المعروف.
[6] الآية 6، من السورة 33: الاحزاب.
[7] الآية 257، من السورة 2: البقرة.
[8] نفس المصدر السابق
[9] «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الإصفهانيّ، ص 533، مادّة «ولي».
[10] الآية 68، من السورة 3: آل عمران.
[11] الآية 62، من السورة 10: يونس.
[12] الآية 65، من السورة 4: النساء.
[13] «تفسير الميزان» ج 10، من ص 89 إلي ص 93. مطبعة الحيدريّ بطهران.
[14] «تفسير بيان السعادة» الطبعة الحجريّة، ص 438.
 الاكثر قراءة في مقالات عقائدية عامة
الاكثر قراءة في مقالات عقائدية عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












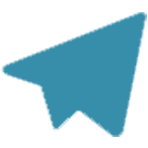
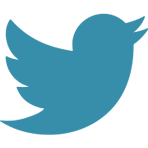

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)